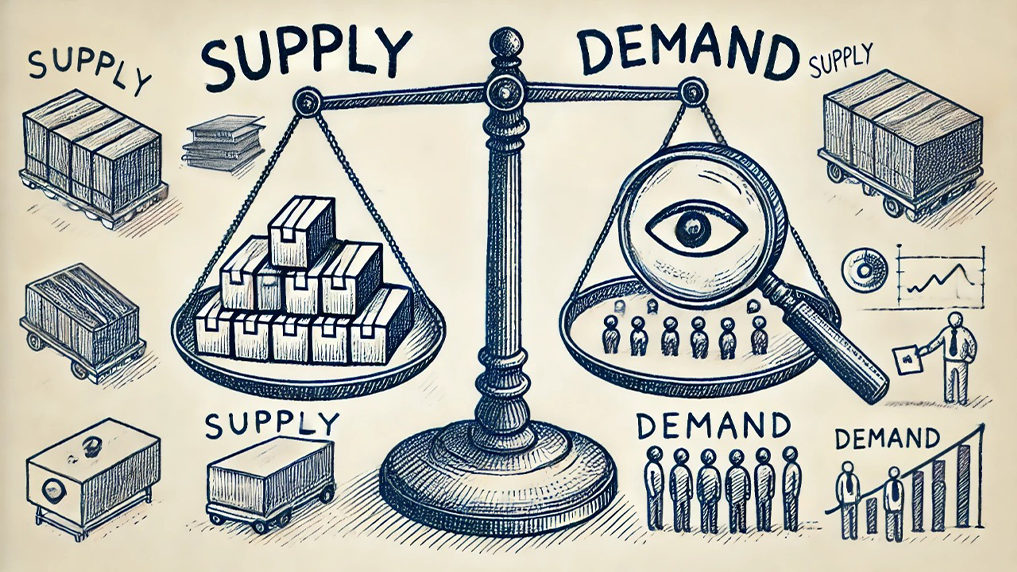
- By food-experts
- October 19, 2025
- No Comments
الأولوية المنسية: ليه لازم ندرس العرض قبل الطلب؟
الأولوية المنسية: ليه لازم ندرس العرض قبل الطلب؟
أحمد سمير رجب – خبير تسويق غذائي، مؤسس ومدير شركة فوود اكسبرتس
الكل لما بييجي يحلل سوق، بيبدأ من نفس المكان: الطلب. الناس عايزة إيه؟ السوق حجمه قد إيه؟ بيشتروا منين وبكام؟ الأسئلة دي بقت المسلّمة الأولى في أي دراسة ويدخل في تفاصيل سيكولوجية المستهلك ..
لكن في وسط الاندفاع ووهج الأرقام، ناس كتير بتغفل عن سؤال أهم، سؤال بسيط لكنه مصيري:
“هل أقدر أوفّر المنتج ده أصلاً؟”
الفرصة ممكن تبان لامعة جدًا على الورق، لكن أول ما تيجي تنفّذ، تكتشف إنك بتبني فوق رمال متحركة، والسبب؟ سلسلة الإمداد ما استحملتش او مش موجودة اصلاً
أنا شفت ده بعيني أكتر من مرة، واتعلمت بالطريقة الصعبة، واتأكدت إن دراسة العرض قبل دراسات الطلب العميقة مش رفاهية، لكنها “فرض عين” لأي حد بيفكر يدخل سوق جديد أو يطلق منتج جديد.
من حوالي عشرين سنة، اشتغلت على مشروع لإنشاء مطعم بمفهوم جديد. اشتغلنا على دراسة السوق بشكل عميق: أذواق الناس، الأسعار، المنافسين، وكل المؤشرات كانت بتقول إننا داخلين على فرصة ذهبية.
لكن لما قربنا للتنفيذ، لقينا مفاجأة: مكون رئيسي في المنيو مش متوفر في السوق بالجودة المطلوبة، ولا بالكمية، ولا بالاستمرارية.
جربنا نستورد، بس لوجستيات معقدة وتكاليف قاتلة خلت الفكرة تنهار، بعد ما كنا صرفنا وقت وفلوس ومجهود على حلم، ماكانش ليه أساس ثابت من الأول.
بعدها بسنين، حصل موقف شبيه في مشروع تاني، المرة دي في مجال مختلف: أكل الحيوانات الأليفة. السوق فيه طلب واضح، والمنتجات المستوردة غالية والناس مش لاقية البديل المحلي و احنا تعاقدنا مع شريك يدينا سر الصناعة و التصنيع.
بدأنا نخطط لإنتاج محلي فعّال. لكن مع أول غطسة حقيقية في ملف العرض، لقينا إن مكون أساسي في التركيبة الغذائية ممنوع استيراده حسب القوانين المحلية و توفيره محلياً نتيجة اليات و انظمة المجازر مايتوفرش العنصر ده.
الفرصة كانت حلوة، لكن مش قابلة للتنفيذ.
اللي تعلمته من التجربتين دول – وغيره كتير – إن البداية الصح مش بتفصيل اللي عند الناس، بل عند الإمكانيات.
قبل ما تسأل “هيشتري ولا لأ؟”، لازم تسأل:
“هقدر أوفّر؟ بالجودة؟ بالسعر؟ بالاستمرارية؟”
وهنا مابنقصدش بس التوريد، لكن بنقصد الجودة، التكلفة، الجمارك، القوانين، الثقافات، العقبات اللي بتقابلك قبل ما المنتج يوصل حتى للسوق.
مثلاً: ممكن يبقى المنتج ممتاز، لكن الجمارك عليه عالية، أو جودته متذبذبة، أو محتاج خامات بتتأخر في الوصول، ساعتها الفكرة كلها تنهار.
وفي مجتمعات معينة، فيه مكونات محظورة لأسباب دينية أو ثقافية، أو حتى مستهلك مش بيتقبلها. كل دي عوامل بتفرق، مش في التنفيذ بس، لكن في جدوى الفكرة من الأصل.
والجميل إن دراسة سلاسل الامداد و التموين مش بس بتوفر مصايب، لكنها ممكن تفتح باب الابتكار.
لو في مكون مش متوفر؟ دور على بديل.
لو الاستيراد صعب؟ فكّر في تصنيع.
القيود أوقات بتخلق أفكار، وتميز، وتخلي منتجك مختلف عن غيرك مش عشان وفرة، لكن عشان حكمة.
اللي بيحصل كمان إن وجود رؤية واضحة لسلسلة الإمداد من الأول بيخلّي الفريق كله واقف على أرض واحدة. بدل ما تبني المشروع على حماس ناتج عن أرقام الطلب بس، بتبنيه على واقع متماسك، والقرارات بتكون بعقل، مش بانفعال.
في النهاية، سلسلة الإمداد مش مجرد تفصيلة تشغيلية… دي عمود استراتيجي لأي نجاح.
أنا شخصيًا شفت قد إيه تجاهلها ممكن يسبب خسائر كبيرة، حتى لما المؤشرات كانت واعدة جدًا من ناحية الطلب.
ولذلك، أي شركة، أو رائد أعمال، أو حتى باحث سوق، لازم يبدأ من السؤال الصح: هل أقدر أوفّر؟
وفي سوق عالمي مفتوح، وسريع، ومليان منافسة، المنهج ده مش مجرد نصيحة، ده ضرورة.
الخلاصة ميزان قوي بين دراسة سلاسل الامداد و التموين و الطلب وقدرتك على توفير القيمة للعميل.
